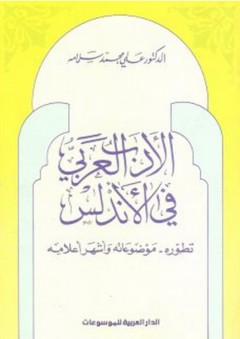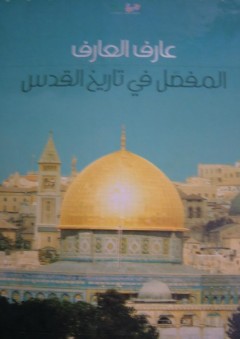نبذة النيل والفرات:تمثل الأندلس في تاريخنا الإسلامي والغربي حقباً مزدهرة، وعصوراً مشرقة، فعبر ما يزيد على ثمانية قرون من الزمن شاد العرب المسلمون في ربوعها حضارة ورقياً، وعدلاً وسمواً، وأقاموا صروحاً شامخة من ألوان المعرفة، ومنها الأدب العربي الذي يعد أثراً من آثار البيئة الأندلسية، يتفاعل معها وتتفاعل معه، لأن أدب أي أمة يتصل إ...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:تمثل الأندلس في تاريخنا الإسلامي والغربي حقباً مزدهرة، وعصوراً مشرقة، فعبر ما يزيد على ثمانية قرون من الزمن شاد العرب المسلمون في ربوعها حضارة ورقياً، وعدلاً وسمواً، وأقاموا صروحاً شامخة من ألوان المعرفة، ومنها الأدب العربي الذي يعد أثراً من آثار البيئة الأندلسية، يتفاعل معها وتتفاعل معه، لأن أدب أي أمة يتصل إتصالاً وثيقاً بحياتها الإجتماعية والسياسية والفكرية، وبيئتها الطبيعية منها والصناعية، ويعد صدَّى لكل هذه العوامل جميعها إيجاباً وسلباً.ولا يظن أحد أن الأدب الأندلسي عبر قرونه الثمانية منفصل عن التراث الإسلامي العربي، بل عكس ذلك هو الصحيح، إذ تربطه به روابط وثيقة، وعرى وطيدة من اللغة والدين، عبر مسيرة الزمن، منذ أن وُجد العرب بالأندلس ومعهم لغتهم العربية العريقة، ومنذ أن أظل الأندلس الإسلام بمبادئه السامية ومعارفه الهادية، فلا عجب إذا وجدنا أصداء هذه الثقافة الأصيلة في أدب العرب بالأندلس، فهذا ليس بدعاً، بل هو من المسلمات البديهية، لأن الأندلسيين سيجدون أنفسهم رضوا أو سخطوا مشدودين بحبال متينة وأربطة وثيقة نحو تراثهم المشرقي، لأنه المنبع الثر الأصيل ذو الروافد المتعددة وإحدى هذه الروافد؛ الأدب الأندلسي.ولقد حظي الأدب الأندلسي بإهتمام الباحثين والدارسين غير أن إهتمامهم به جاء دون إهتمامهم بآداب العصور المختلفة، كما ان دراستهم له جاءت ممثلة لإتجاهين مختلفين: فالإتجاه الأول يهتم بدراسة عصر أو عصرين من العصور الأندلسية والإسهاب فيه، أو فيهما، إسهاباً يدل في مجمله على صبر وأناة، ودراسة وخبرة، ولكن بالرغم من قيمته العلمية للدارس المتخصص، فإنه عبء ثقيل ومضن على غيره من طلاب المعرفة وشداة الثقافة غير المتخصصين، لأنهم سيجدون عناء وعنتاً في الإحاطة بجوانب الأدب الأندلسي عبر عصوره العديدة التي تصل إلى ستة عصور، وقد تزيد عند بعض الباحثين.والإتجاه الثاني يدرس الأدب الأندلسي دراسة مجملة شعره ونثره دون بيان لملامح كل عصر على حدة، ولو بإيجاز بعين الطالب والمطلع على الإحاطة الشاملة بهذا الأدب عبر مسيرته الطويلة، وما حدث فيه من تطور وتجديد أو جمود وتقليد، فجاءت الدراسة عند أصحاب هذا النهج غير وافية بالغرض المنشود، والأمل المرجوّ، لأن هذا يوحي بأن الأدب الأندلسي ظل جامداً دون تطور منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس، والأهم من ذلك أن معظم أصحاب هذا الإتجاه يلقون بالنصوص الشعرية والنثرية بوفرة دون تحليل يعين القارئ على فهم هذه النصوص ثم تذوقها، والوقوف على مظاهر الإبداع فيها أو التقليد، وإن أتى ذلك فإنه يأتي في ندرة وفي إستحياء، إزاء ما رأه الدكتور علي محمد سلامة من إسهاب مضن في النهج الأول وإجمال شديد في النهج الثاني وجد نفسه مدفوعاً إلى إتباع طريق وسط، لا هو بالمسهب الممل، ولا هو بالموجز المخل، فدرس الأدب الأندلسي عبر عصوره المختلفة مبيناً أهم سمات هذا الأدب في كل عصر على حدة، ومهد لذلك بدراسة تاريخية وإجتماعية وثقافية للأندلس لا مندوحة عنها لدارسي الأدب الأندلسي، ثم اتبع ذلك بدراسة الفنون الشعرية المستحدثة، والتقليدية، وخصائص كل فن مع ذكر الشواهد على ذلك عندما يتطلبها الموضوع والسياق، ثم تناول بالدراسة خمسة شعراء من مشاهير الأندلس ملقياً الأضواء على حياتهم وخصائص أشعارهم، ثم تناول الدراسة الفنية الشعر الأندلسي، وإخضاعه لمقاييس النقد العربي، أما الموشح والزجل فقد خصص لهما باباً خاصاً وضح فيه نشأتهما ثم تطورهما مع التمثيل، أما النثر فقد درس فنونه المختلفة، وبيّن خصائص كل فن، وما فيه من تقليد وأصالة، أو جدة وطرافة.